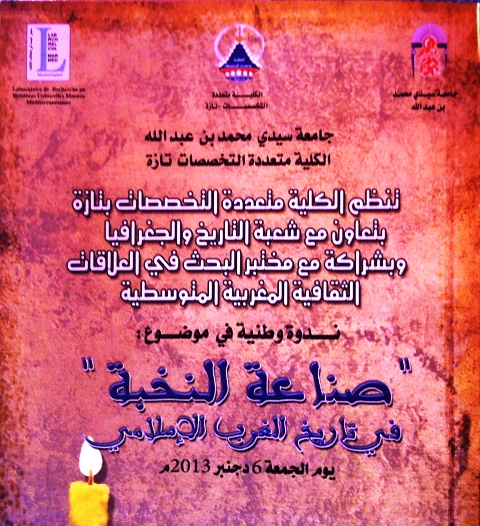تقرير عن ندوة “صناعة النخبة” في تاريخ الغرب الإسلامي
نشرت بواسطة:ABDELMALEK NASSIRI
بتاريخ 2013-12-13
في أرشيف مواد الموقع
التعليقات على تقرير عن ندوة “صناعة النخبة” في تاريخ الغرب الإسلامي مغلقة
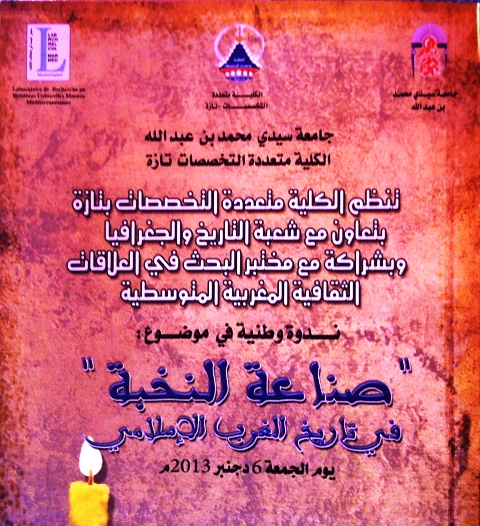
تقرير عن ندوة
“صناعة النخبة” في تاريخ الغرب الإسلامي
ذ. محمد البركة
يعتبر إشكال “النخبة” من القضايا التي كانت وستظل تفرض أسئلتها على الباحثين بتعدد تخصصاتهم، إذ ورغم تعدد الأبحاث المنجزة إلا أن أغلبها عالج الموضوع في إطار سياق زمني خاص له أسئلته الكائنة والممكنة، أو في إطار سياق عام رصدا لملامح “النخب” خلال حقب متعددة من تاريخ المغرب، اعتمادا على منهج استقرائي، وهذا ما جعل هذه الأبحاث غير مجلية لنوعية المقاربة المعتمدة، حتى بعد تقديم حصيلة البحث والمعالجة، ناهيك عن عدم تعرضها لأنواع كثيرة من “النخب” واقتصارها على البعض دون الآخر.
وإذا كانت هناك أعمال مستقلة قد سبق وأن اهتمت “بالنخب”، فإن بعضها ظل منحازا إلى مجموع التحولات والأسئلة الراهنة، وخاصة السياسية منها، وليس للزمن التاريخي قيد الدراسة بكل تجلياته، إذ الحديث عن “النخبة” هو حديث عن “النخب” أولا على اختلاف تخصصاتها وأدوارها، وهو كذلك حديث عن نسق جامع لهذه “النخب” ثانيا، نسق لن يكون ذا معنى عند المؤرخ إلا إذا تم تأطيره بحقبة زمنية محددة، لها سياقها وظروفها العامة التي تطال كل “النخب” على تعددها من جهة، وعلى تعدد مصادر الكتابة عنها من جهة ثانية.
على أن هناك أعمال حاولت تلمس “نخبة” بعينها من خلال نص مصدري محدد، إلا أن خلاصاتها لا يمكن أن تطال كل تلك “النخبة” عينها، ولا حتى الحقبة قيد الدراسة كلها، لأنها في المصدر مجرد عينة، لتناولها والتعرض لها، لها خلفياتها وسياق ورودها، مما يجعلها غير معبرة عن الواقع التاريخي للحقبة المعنية، وغير قادرة على رسم ملامح تلك النخبة إلا من زاوية ذلك المصدر المعتمد نفسه (نوعية الخطاب، خلفية الخطاب).
لذلك وتأسيسا على ما سبق، احتضنت الكلية متعددة التخصصات بتازة يوم الجمعة 6 دجنبر 2013م ندوة وطنية في موضوع: “صناعة النخبة” في تاريخ الغرب الإسلامي، ندوة سعت إلى البحث عن مقاربات متنوعة تكون أكثر عمقا أثناء تلمس القدرات الخاصة والأدوار المتعددة “للنخب” في تاريخ الغرب الإسلامي، مقاربات لا تستثني دورا من الأدوار التي قامت بها النخبة لصالح الدولة أو المجتمع أو هما معا، بحثا عن حالة الالتحام أو الانفصام التي يمكن أن تعقد بينها وبين قضايا عديدة للدولة أو المجتمع، كما لا تهمش ولا تقصي أدوار “النخب” قبل وأثناء قيام الدولة، أو حتى بعد قيامها بصناعة نخبها، أو مع المجتمع، لأن “النخبة” تظل حاضرة موالية أو معارضة على اختلاف وتعدد مواقفها.
وتحديدا للمفهوم ورفعا للبس تنزيل المفهوم الراهن على “نخبة العصر الوسيط”، جاء عرض الأستاذ نور الدين جلال في موضوع مفهوم النخبة بين الجدل المنهجي والواقع التاريخي، عرض حاول فيه إبراز طبيعة السجال الواقع أثناء دراسة وتحليل النخبة/النخب، منذ انطلاقه خلال بداية القرن العشرين. ذلك بأن إشكالية دراسة النخب ظلت مرتبطة بالتطور الحديث لعلم الاجتماع. علما بأن أصل الاختلاف مند البداية يكمن في الاختلافات المنهجية حول الطريقة التي يجب معاينة واقع وسلطة “الجماعة/الفئة الحاكمة”. فإذا كان كل من موسكا وبريطو يقول الأستاذ “أول من تطرقا إلى هذه الظاهرة، فإن الاختلاف الحاصل بينهما سرعان ما تعمق بولادة اتجاهين اثنين، الاتجاه الأول يرى أن المحددات الاجتماعية والهيكلية هي التي يجب أن تحظى بالأهمية، نظرا لأن النخب متجانسة في حد ذاتها. أما الاتجاه الثاني فيؤكد على آثار العمل السياسي في تجزيء هذه الفئات إلى فئات غير متجانسة”.
والواقع أن هذه النظريات -حسب الأستاذ- حتى وإن لم تلق الصدى القوي -في بداية الأمر- في فرنسا، فإنها في مقابل ذلك لقيت اهتماما كبيرا في البلدان الانجلوساكسونية، حيث إن التقليد السوسيولوجي في هذه البلدان، يأخذ بفكرة النخبة كبديل سياسي للمفهوم الماركسي “للطبقة الحاكمة”. مما أدى إلى احتدام النقاش الذي تركز بالأساس حول ما إذا كانت هذه الظاهرة مفرد (النخبة) أو جمع (نخب)، وهو أمر دل على حالة التداخل بين الأيديولوجيا واللغة، تداخل أدي إلى الزيادة في تعقيد فهم الظاهرة، زيادة وجب أن تأخذ بالاعتبار حصيلة تطور الدراسات التجريبية الكمية والكيفية أثناء معاينة هذه الظاهرة، التي زادت أصلا من تعقيد السجال والنقاش حول النخبة/النخب.
إن تطور الدراسات في هذا المجال أدى إلى اتساع وتعدد المفهوم الذي يمكن أن يُقدم للنخبة/ النخب، إذ سيظل متجددا متبدلا، ومُتجاذبا بين تأثير المنهج وحراك الواقع، لكنه بالتأكيد لن يكون محددا لمفهومه خلال العصر الوسيط إلا من حيث الإطار العام لكن بمسميات أخرى حتى ولو تعددت وظائفيا.
وتأكيدا على ما سلف، حاول عرض الأستاذ محمد البركة الموسوم بـ”النخبة” في تاريخ الغرب الإسلامي بين العلم والسياسة (إيضاح وإفصاح)، التأكيد بأن الالتباس الحاصل في مفهوم “النخبة”، هو ما يجعل الموضوع متجدد العرض والبحث، إذ رغم المفاهيم الكثيرة المعروضة للتعريف به، إلا أن حقيقة المفهوم التاريخي للفظ بما يناسب واقع تاريخ الغرب الإسلامي هو ما يجعله متكرر المناقشة، سعيا لطرد الوهم الواقع على المفهوم نظريا، ورغبة في تنزيل حقيقته بما يعبر عن واقعه التاريخي عمليا. فإذا كان مفهوم “النخبة” مفهوم وصفي يدل بالتقريب على فئة تحظى بطابع التميز داخل حقل اجتماعي معين، تميز يجعلها تمارس نوعا من الريادة داخله أو في علاقته بالمحيط، بما تتوفر عليه من مؤهلات، فإن البعض من هذه الفئة ممن يندرج في أحد أنواعها، أمكنه أن يصنف في إطارها ولو بدون مؤهلات، بل بحسب وسائط متعددة (ولاءات، علاقات، خدمات…).
وبما أن تتبع مفهوم “النخبة” عبر تاريخ المغرب، وخاصة تاريخ الغرب الإسلامي، يساعد في الوقوف على تاريخ هذا المفهوم، وعلى معرفة مجموع المفاهيم المرصودة له عبر التاريخ، فإنه في حقيقة الأمر يساعد في فهم طبيعة الانتقال الحاصل، ليس للمفهوم فقط بانتقاله من البسيط إلى المركب، أو بتحوله من الجزئي إلى الكلي، بل كذلك للفكر -بما هو إعمال للعقل- في قدرته على إبداع وسائط جديدة قادرة على التحكم فيها، وللسياسة -بما هي تدبير- في قدرتها على ابتكار وسائط سديدة بغرض استمالة “النخب” وصناعتها، وللسلطة –بما هي أداة تطويع- في قدرتها على إخضاع نخب زمانها خدمة لمشروعها.
فمظاهر الاختلاف الحاصل بين مجموع المفاهيم المرصودة “للنخبة” يقول الأستاذ: (تكمن في مجموع صور النخب الحاضرة في الذهن لحظة الصياغة، بحثا عن الجامع بين هذه الصور، وسعيا لصياغة مفهوم قادر على استيعاب أغلب الصور المتمثلة “للنخبة”، كما أنه يرجع إلى الاختلاف الحاصل بين قدرات الصائغ في تجميع هذه الصور والتعبير عنها في مفهوم يكون لصيقا بزمانه، غير منحاز إلى الزمن الراهن، إذ غالبا ما يتم استحضار صور راهنة للتعبير عن المفهوم المنتسب لزمانه. مما يجعل مفهوم “النخبة” مفهوم غير واضح، وغير سالم من الانتقادات، خاصة عند أولئك الذين اعتبروا “النخبة” أداة محركة للتاريخ، وفاعلة محورية فيه، إذ الفاعلية التاريخية للنخبة برأيهم هي من جعلتها تحظى بدور ريادي في تحريك التاريخ وصناعته).
ولما كان المؤرخ معني بصياغة مفهوم “النخبة”، ومدعو للتعبير عن المفهوم بعد البحث في تجلياته خلال حقب زمنية محددة أو متعددة، كان الباحث في تاريخ الغرب الإسلامي مدعو بشكل أدق للاهتمام بهذه الصياغة، لأن مظاهر تشكلها بدأت مع تاريخ الغرب الإسلامي، ولا يمكن التأسيس لمفهوم تاريخي “للنخبة” إلا برصد سياق التكوين، الذي تجاذبته سلطتين اثنتين السلطة العلمية والسلطة السياسية، أو العلم والسياسة.
في مقابل ذلك حاول الأستاذ سعيد بنحمادة ومن خلال عرضه الموسوم بموقف العامة من “النخبة” بالغرب الإسلامي، أن يبرز برأيه تصورين يكادان يكونان متناقضين حول “النخبة”: تصور شكلته “النخبة” حول ذاتها، وآخر عبارة عن موقف صاغته العامة عنها. ذلك بأن المتأمل في ما كتبته “النخبة” عن نفسها يلاحظ المنظور الإيجابي الذي بلورته عن نفسها؛ سواء على مستوى الوظائف، أو فيما يخص المظاهر، أو القيم. في المقابل يطالع الخطاب الشعبي بتمثلات سلبية عنها، من قبيل النقد والحذر، والتسلط، والجشع، وغيرها من المؤاخذات التي عابتها العامة عن “النخبة”.
ومن ثم فبقدر ما تتكامل تلك المواقف، فإنها كذلك تفيد في تنويع المصادر التاريخية للموضوع؛ ذلك بأن مجمل ما كُتب عن السلاطين، والأمراء، والكتّاب، والعمال، والقضاة، والفقهاء، والمحتسبين، والشرطة، وغيرهم من رموز “النخبة”، مستمد من كتب التراجم والسير والطبقات والتاريخ الحدثي. في حين أن مجمل ما قيل عن “النخبة” من طرف العامة فمصدره كتب الأمثال الشعبية، والأزجال، ومصنفات لحن العامة، والأشعار، مما يعطي نوعا من التزاوج في المادة المصدرية، وهذا ما يستلزم الربط بين الثقافة العالمة والشعبية، أثناء النظر إلى الموضوع من زاوية متكاملة، في إطار تجديد مفهوم الوثيقة والحدث التاريخيين، وآليات اشتغال المؤرخ.
أما الأستاذ عبد المالك ناصري فقد سعى إلى معالجة قضية المدينة والنخبة، من خلال موضوع المجتمع الحضري و”صناعة النخب” ببلاد المغرب خلال العصر الوسيط، وهو الموضوع الذي صدره بفرضية تعتبر أن النظام الذي تخضع له ساكنة المدن العواصم المغربية يختلف بشكل جذري عن النظام الاجتماعي لمدينة أخرى، لها وضع عادي وذات هيكل اجتماعي واقتصادي ومعماري خاص بها. فسكان المدينة السلطانية يؤلفون مجموعة بشرية غير متجانسة، من حيث تركيبتهم الإثنية أو الدينية، فهم في غالب الأحيان يشكلون مزيجا اجتماعيا فسيفسائيا، من حيث وضعهم الاجتماعي أو نشاطهم الاقتصادي أو مهامهم وتكليفاتهم الوظيفة، إلا أنهم رغم هذا الاختلاف فإنهم يرتبطون، أولا وأخيرا، وبدون استثناء بشخص الأمير، إما بشكل مباشر أو غير مباشر.
وهذا ما جعل “النخبة” العلمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، الملتحقة بحاضرة السلطان بمبادرة منها أو بدعوة منه، متأثرة بالثقافة الحضرية كما هي متداولة في المدن العواصم، ومكنها من اكتساب وضع متميز، ساعدها على تركيز وضعها وتنامي نفوذها.
وفي محاولة لذكر بعض أدوار النخبة، تعرض الأستاذ أحمد الصديقي إلى موضوع “النخبة العالمة” بين المجتمع والدولة بالغرب الإسلامي، ذلك بأن دور “النخبة العالمة” بحسب الأستاذ يكمن في توزيع الأدوار بين مكوناتها، وعلاقة أدوارها وانعكاساتها على الفعل السياسي، بيانا لحجم وقوة تأثيرها، إضافة إلى الأدوار العلمية التي لا تخلوا أحيانا من هواجس وهموم مجتمعية؛ وهذا ما يفسر تصاعد وثيرة حجم إنفاق السلطة على محاولات تدجين “النخب” وترويضها بشكل مستمر، فضلا عن الأهمية الكبرى التي توليها هذه الكيانات السياسية للتحكم في توجيه وسائل التواصل، بما فيها السعي عبر “نخبها” إلى إنتاج المصنفات والكتب لبناء توجه عام يساير مطامح ومطامع الدولة القائمة.
لقد عملت “النخبة العالمة” على طرق سبل عديدة في نشر الفكر والثقافة، مستعملة في ذلك جل الطرق المتاحة في التواصل مع الناس، مثل تنشيط مجالس الإقراء والوعظ وحضور المناظرات وتقديم الفتاوى وتأليف وتصنيف الكتب، وإذا استثنينا الأخيرة فإن الطرق الأولى غلب عليها السماع والتلقي المباشر، إلا أن عملية التأليف والكتابة شكل فيها الكِتاب وسيطا أمينا وأداة تواصل بين “النخبة العالمة” والناس على اختلاف جهاتهم.
إن التحولات العامة التي مر بها مجتمع الغرب الإسلامي، خلفت “نخبا” عالمة متعلمة ومعلمة؛ تباينت واختلفت أدوارها وفقا لتنوع مشاربها وأصولها الفكرية وتوجهاتها السياسية، مما يثير شهية مقاربة طبيعة العلاقة التي نسجت بين “النخبة العالمة” والمجتمع من جهة وعلاقتها بالسلطة من جهة ثانية.
أما الأستاذ محمد ياسر الهلالي، فقد عرض لموضوع بعض أوجه التعارض بين “النخبة العالمة” والمخزن المريني، في عرض حاول من خلاله البحث في حالة التعارض بين الفقهاء والمخزن المريني انطلاقا من أسس ذلك التعارض، ووصولا إلى المصير الذي آل إليه الفقهاء المعارضون من استقطاب، ونفي، وسجن، وقتل…، مرورا بتشريح مواضيع التعارض ومحطاته في السياستين الداخلية (الجباية، والتحبيس، والمدارس، والقرويين) والخارجية (الحملات المرينية في اتجاه الشرق)، والوقوف عند تمظهرات معارضة الفقهاء للمخزن من قبيل رفض لقاء السلطان، ورفض تولي الخطط المخزنية، وتجنب عطايا السلطان، وعدم مجاراة سياسات المخزن. وفي كل هذه المحطات والتمظهرات، تبرز آليات وظفها الفقهاء في معارضتهم للمخزن من فتوى ونصيحة وغيرهما.
وتدقيقا لبعض عناصر الموضوع، حاول الأستاذ التعرض لقضايا ثلاث تبرز حقيقة الموضوع، القضية الأولى حين ركز الحديث عن التعارض النظري بين العلماء والمخزن، ومدى وعي كل طرف منهما بخلفياته، متسائلا ما إن كان لهذا الشق من التعارض، الذي يجر من ورائه تاريخا طويلا، انعكاس على الواقع التاريخي؟، والقضية الثانية تتعلق بطبيعة تناول بعض الأجناس المصدرية وخاصة كتب الأخبار لبعض مواضيع التعارض بين السلطة والعلماء، ومع هذا الجنس يتساءل المؤرخ إن كان بالإمكان مجاراته في القضايا ذات الصلة؟، أما القضية الثالثة، فتتمثل في مناقشة خلفيات معارضة العلماء لمشروع المدارس المرينية عند بداياته، والتساؤل ما إن كانت تلك المعارضة ذات مرجعية دينية أم سياسية؟ رابطا هذه القضية بأخرى ذات أهمية جوهرها المقارنة بين معارضة البدايات ومعارضة النهايات.
وفي موضوع فريد عنوانه “النخبة النسائية” في تاريخ الغرب الإسلامي -العصر المريني نموذجا-، حاول الأستاذ محماد لطيف دراسة موضوع “النخبة” في تاريخ الغرب الإسلامي، رغم إقراره بطبيعة الصعوبات والعوائق المتعددة التي تحيط بالموضوع، ذلك بأن معظمها يتصل بمسألة المصطلح وما يعتريه من التباس وغموض، وبالمصادر التاريخية وما تعانيه معلوماتها من شح وابتسار. وهي صعوبات تزداد أكثر عند الحديث عن “النخبة النسائية” بالمغرب الأقصى خلال الفترة المرينية.
وإذا كانت طبيعة الثقافة المدونة لمصادر الفترة المدروسة قد أبرزت تشبع المرحلة بالثقافة الأبوية المؤكدة على سيادة الصيغ الذكورية، فإن في فكرة التفاوت بين الجنسين، واحتلال المرأة موقعا دونيا وثانويا، مثل إحدى الأفكار التي تشبثت بها ذهنية مختلف شرائح مجتمع الغرب الإسلامي. مما أدى إلى الحط من قيمة المرأة، والتقزيم من مكانتها، فنظروا إليها يقول الأستاذ “نظرة تنم عن الإهانة والدونية، وبكل ما يفوح برائحة التعصب والازدراء. كما اعتبروها كيانا مشلولا، وعنصرا ناقصا لا قيمة له، وبأن وجودها الاجتماعي لا يتحقق إلا من خلال الرجل وتحت ظله”.
ورغم كل ذلك، فإن الباحث لا يعدم من أخبار “نخبة” من النساء ما يميط اللثام عن مشاركتهن في الحياة السياسية، وما يكشف عن فاعليتهن في توجيه الكثير من الأحداث، ونصيبهن في تدبير شؤون الحكم، واتخاذ قرارات حاسمة سواء على مستوى الدولة أو القبيلة، إلى حد يمكن معه القول بأنه يصعب فهم بعض التطورات السياسية التي حدثت طيلة الحقبة المرينية، دون معرفة الأدوار التي قامت بها المرأة في هذا الاتجاه، وهذا ما يستدعي ملامسة الموضوع من زوايا تتعلق بصعوبة تحديد مفهوم وحدود “النخبة النسائية” ومدى مشروعية الحديث عنها في الفترة المرينية.
أما الأستاذ عبد الهادي البياض وفي موضوع له بعنوان: جوانب من تاريخ “النخبة الصوفية” بمغرب العصر الوسيط (دلالات المفهوم وتجليات الأدوار)، أقر بأن البحث في موضوع “النخب” من زاوية مجال الولاية والصلاح ما زال يتلمس طريقه بخطى حثيثة، نظرا لما يكتنفه من صعوبات منهجية وموضوعية. ذلك أن استقراء مفهوم”النخبة” في المجال المنقبي يعد مجازفة غير مأمونة العواقب قد تؤدي إلى مزالق على مستوى النتائج المنتظرة. ذلك بأنه إذا كان مفهوم “النخبة” مرادف لمفهوم “الخاصة” أو”الصفوة” على سبيل القياس والتجاوز، فهذا من شأنه أن يفرز مسألة التمييز والتميز، وهو ما ترفضه بشدة أدبيات وتعاليم المتن المنقبي، القائمة على نبذ التمايزات داخل النسيج الاجتماعي، فبالأحرى أن يتم تداولها داخل المحاضن الصوفية من رباطات وزوايا.
حيث تتحاشى كتب المناقب والتصوف كل ما من شأنه أن يسلط الضوء على ولي صالح في سياق العجب والرياء والسمعة، حتى وإن تعلق الأمر بكرامة باهرة تحققت في مجال من المجالات المجتمعية. ولتجاوز ذلك، سعى الأستاذ إلى تتبع ورصد كل ما من شأنه أن يسهم في ثلم الفجوات ورتق البياضات التي تكتسح بناء جسم الموضوع المذكور من خلال البحث في محددات “النخبة” في المجال الصوفي المغربي، ومن خلال البحث في طبيعة الأدوار التي اضطلعت بها هذه الفئة في الحقبة المدروس.
أما الأستاذ حميد تيتاو وفي عرضه حول أصول “النخبة العسكرية” وأدوارها في مغرب العصر الوسيط، فقد استند في معالجته على محدد رئيس، يتمثل أساسا في الحضور المكثف للحرب في بنية الدولة المغربية خلال المرحلة المعنية بالدراسة، حضور طبعها بالطابع الحربي والعسكري، وخلف مجموعة من المظاهر العسكرية التي تجلت بعض معالمها في المكانة المتميزة التي حظيت بها عناصر الجيش بالنسبة لدولة قام فيها هذا الأخير بالدور الحاسم في بنائها وتكونها، وفي الحفاظ على استمراريتها. لذلك كان طبيعيا أن تتغلغل هذه “المؤسسة” في مختلف دواليب الدولة لتسيطر على أهم خططها، وتتحكم في أهم قراراتها بما في ذلك إقرار السلطان، أحيانا، على كرسي ملكه أو إبعاده أو خلعه، لدرجة يمكن معها الحديث عن “نخبة” متميزة بنفوذها وثروتها ومكانتها داخل السلطة أولا، وفي المجتمع ثانيا.
على أن استعمال مصطلح “النخبة” في مغرب العصر الوسيط يستدعي من جهة الأستاذ استحضار الباحث لما قد يحيط هذا الاستعمال من غموض أو التباس، مما يدفع، بالضرورة، إلى تحديد طبيعة التعريف الذي يمكن اعتماده للمصطلح. وهو أمر يتعلق كذلك حتى باستعمال مصطلح “النخبة العسكرية”، مما يستدعي الوقوف عند المحاذير المتعلقة بهذا النوع من التوصيف، إذ من الصعب أن يغامر الباحث ويستخدم مثل هذا المصطلح في مجتمع لم تستطع الدولة فيه بعد إخضاع الحرب والظواهر المرافقة لها لعمليات المنع والكبح والتحويل واحتكار العنف، نظرا لانبثاقها من بيئة قبلية كان فيها معظم الأفراد من الذكور، فيما يبدو، يتقنون حمل السلاح وركوب الخيل منذ الطفولة، وبيئة اجتماعية يتحول فيها الفلاح والحرفي والسلطان وصاحب القلم أحيانا… وقت السلم، إلى جندي ومحارب زمن الحرب، مما يعقد من إمكانية الحديث عن “نخبة عسكرية”، متفردة بخصائص اجتماعية معينة من حيث التشكل والبناء، التنظيم، المهام، السلوك، القيم، التراتبية…، تميزها عن باقي “النخب” الأخرى.
غير أن تأكيد الأستاذ على هذه الصعوبات المنهجية، لم يمنعه من اعتماد تعريف مبسط وتقريبي يحيل فيه مفهوم “النخبة” إلى فئات تحظى بنوع من التميز داخل حقل اجتماعي ما، كما تمارس نوعا من الريادة داخل هذا الحقل، وتوظيف التصنيف الأكثر تداولا لمفهوم النخب، والمتعلق بالجانب القطاعي المميز بين نخبة سياسية وأخرى عسكرية وأخرى تقنية وغيرها.
لقد حاولت ندوة “صناعة النخبة” في تاريخ الغرب الإسلامي أن تعمق النقاش والبحث في مفهوم وأنواع وتاريخ هذه البنية، وأن تقر بصعوبة اعتماد لفظ “النخبة” إلا ما كان فعلا إجرائيا، دلالة على “الخاصة” ليس في علاقتها بالدول، بل بالدولة والمجتمع معا، كما أن الندوة حاولت من جانب مناقشتها أن تحدد ملامح أدوار هذه “النخبة” في تشكيل النسق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي لبلاد الغرب الإسلامي، في تفاعل مع الدولة والمجتمع عبر محطات تاريخية تنتسب للعصر الوسيط، وانعكاس كل ذلك على طبيعة المادة المصدرية المحكي عنها في المصادر على تنوعها واختلافها، مما يحتم على الباحث في الدراسات التاريخية مراعاة أغلب أنواع هذه المصادر أثناء دراسة للموضوع، بما هي على اختلافها انعكاس لموقف وفهم وفكر وتعبير أريد تصريفه، وهذا يعني أن المؤرخ أثناء استرشاده بنتائج علم الاجتماع، لزمه أن لا ينسى أن التاريخ كان وسيظل هو مختبر علم الاجتماع.